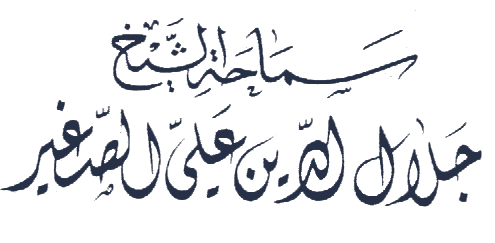رضا الحيدري (مجموعة حكيميون) أغلب الديانات والمذاهب الفكرية بما فيها الماركسية تؤمن باليوم الموعود وظهور المنقذ الذي يرفع الظلم والحيف عن الجميع وينشر العدل، فما هو برأيكم السبب في ذلك؟ هل هي حاجة الانسان الى الكمال؟ أم تعلّق الضعفاء بمثل هذا المنقذ؟
الجواب: مما لا شك أن طلب الصورة المثلى والتوق لتجسّدها على الأرض لتعميم العدالة في العلاقات بين الناس وفي توزيع الثروة وتأمين الاحتياجات بطريقة إنسيابية لا ظلم ولا حيف فيها هو سجية إنسانية، وقد عبّرت الإنسانية في تاريخها الطويل عبر منظوماتها الفكرية المختلفة سواء كانت هذه المنظومات سماوية أو كانت إلحادية عن ذلك بطرق عدّة ولكنها متفقة جميعاً على ذلك، فحينما طرح افلاطون تصوّره للجمهورية الفاضلة أو حينما طرح ماركس تصوّره عن عهد الشيوعية إنما أشارا إلى طبيعة هذا التوق لتحقيق ذلك، هذا ناهيك عن الأديان التي تحدّثت جميعها عن يوم تتحقق فيه هذه الأمور وقد عبّر القرآن الكريم عن ذلك بصورة صريحة بقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون (سورة الأنبياء: 105).
وحينما يكون الأمر سجية خاصة بالإنسان، عندئذ يمكن أن نتلمس تنوعاً في التعبير عنه، كما ونلمس أيضاً ظروفاً مختلفة تذكّر به وتبرزه من الكمون والخفاء في طوايا النفس إلى الذاكرة الحاضرة التي يطلب حصولها ويعبر عن إشتياقه لها، ولهذا نلمس الإتجاهين معاً، أي ما عبّرت عنه بطلب الكمال والذي يشير إلى أن النفس هي التي تطلب ذلك، أي أن النزعة ذاتية، أو أن يكون الواقع الخارجي هو الذي يضغط باتجاه ذلك كأن يكون ظلماً يريد أن يتخلّص الإنسان منه، وفي تصوري أن الأصل في ذلك هو النزوع الذاتي نحو الكمال، لأن الظلم حينما يحصل ويطلب الإنسان التخلّص منه، إنما يطلبه لأن هناك سجية في داخله تدفع به نحو الكمال، مما يجعله يطلب التخلص من الظلم، وهذه ميزة من مزايا الذات الإنسانية عن بقية الذوات الحية، فالظلم يقع في عالم الحيوان، ولكن من الواضح أننا لا نرى أن الحيوان يطلب الكمال في توزيع الثروة الطبيعية أو في العلاقات بين الكواسر والمعشبة منها، ولولا هذا النزوع لما وجدنا الإنسان المظلوم يشتكي من الظلم الذي يحيق به، وإنما سيكتفي في أحسن الصور إلى الهروب منه، وإن لم يستطع سيستسلم له.
ولكن الطرح الديني لمسألة المنقذ تميّز عن غيره من الطروحات بأنه أوجد نظماً لإدارة عمل هذه السجية، ولم يتركها أسيرة للظروف ولتقديرات الإنسان لطبيعة الكمال الذي يريد، إذ أن هذه التقديرات ستختلف من إنسان إلى آخر، ومن وقت لآخر، فقد يرى الإنسان أن كماله في الحصول على المال، بينما يرى الآخر في أن له هذا الحق أيضاً، ومن دون نظام يتحكم في توزيع هذا الحق لوجدنا ان النزوع إلى الكمال هو بحد ذاته يمكن أن يكون نافياً له من خلال اصطدام هذين والذي يتجسّد على شاكلة صراع بين الحقين، مما يؤدي إلى الحروب والتجاوز على حقوق الآخرين، ومن هنا كان سر التشريعات التي أنزلت لكي تنظم العلاقة بين أصحاب الحقوق، وهذه التشريعات التي تعاقبت في نزولها على البشر، حوّلها الناس الذين خرجوا من ربقة الدين إلى نظم أصبحت تعرف بالقانون، ولكنها في الأصل تعود إلى تلكم التشريعات السماوية.
ولم يكتف الفكر الديني بمجرد طرح التشريعات لأن التشريع أو القانون يمكن أن يضعه الناس بمعزل عن صوابيته، ولهذا كان إرسال الأنبياء ملاصقاً لوجود هذه التشريعات، بعنوانهم المجسّدون الاجتماعيون لمهمة الرقي إلى الكمال الذاتي والاجتماعي، ولهذا لم تكتف الأديان بطرح أفكارها عن الكمال وإنما عضّدته بالوجود الاجتماعي للكاملين من نفس الناس، فلم تتحدث عن الكاملين من الملائكة، وإنما تحدثت عن الكاملين الفعليين من نفس البشر ومن نفس البيئة التي يحا عليها الإنسان، لتري المجتمع أن فكرة الكمال ليست فكرة مثالية أو طوباوية لا ترى إلّا في التصورات والأحلام، وإنما هي وجود اجتماعي يتجسد على شكل ظاهرة اجتماعية تسميها بظاهرة الأنبياء، وان الكمال له مشروعه التطبيقي على الأرض.
وبطبيعة الحال ما كان لهذه التشريعات الدينية أن تختلف في تعريف الكمال، فقد أكّدت على ما نسميه في أروقة الفلسفة الاجتماعية بثبات المعايير والقيم، فالحق والجمال والخير والعدل والظلم والصدق وما إلى ذلك يبقى تعريفه ثابت وإن اختلفت الظروف الاجتماعية التي تعترض حياة الإنسان، ولكن النظم البشرية التي فارقت الدين اختلفت بشكل موسع في هذا التعريف، فالحق يسمى عند طرف حقاً، ولكن طرف آخر لا يصفه بهذه الطريقة، بل قد يصفه بطريقة مناقضة تماماً لهذا الوصف، ومن هنا نشأ لدينا مصطلح القيم المتحوّلة، وبسبب عدم الثبات هذا دخلت الأمم في حروب، رغم أنها كلها تتحدث عن طلب الكمال، ولكنها حينما اختلفت في التعريف دخلت في سير معاكس للكمال وهو ما يطلق عليه الإسلام بالقيم الجاهلية، وما نراه اليوم من صراعات وحروب وأزمات يعبّر عن تلك المشكلة الفلسفية.
وقد تميّز فكر أهل البيت صلوات الله عليهم عن غيره، بأنه لم يكتف بطرح المعايير الخاصة بالكمال، لأن مجرد الطرح الفكري والدعوة إليه، لا يعني أن المطلوب سيتجسد في الواقع الاجتماعي، كما وأن عامة الناس قد لا ترقى إلى معرفة هذا الطرح، أو لا تعي مستلزماته، ولم يكتف بالمجسّد الاجتماعي للكمال الذي يمر مروراً طارئاً في التاريخ، كما اكتفت المدارس الإسلامية المناهضة لأهل البيت عليهم السلام بالنبي محمد صلوات الله عليه وآله، ووصف عصره بأنه العصر المثالي، بل إنها اعتبرته أفضل العصور على الإطلاق في عمر البشرية فتناقضت بهذا القول مع فكرة المنقذ، بل وأفشلت الفكرة، لأن المنقذ جاء على شكل الرسول صلوات الله عليه وآله، وطرح مشروعه للكمال (رحمة للعالمين)، ولكنه ما ان طرحه مشروعه حتى غادر الدنيا وسرعان ما عادت الدنيا لطبيعتها تبحث عن المنقذ من جديد، لكثرة الظلم الذي حاق بها، وإنما أصّرت هذه المدرسة المباركة على ديمومة وجود المجسّد الاجتماعي للكمال والذي أطلقت عليه دور الإمامة، وقالت بأنه لا يمكن أن تخلو الأرض من حجة، ومرادها ضمن نطاق بحثنا هنا هو هذا التجسّد التاريخي للكمال، بحيث يكون هذا التجسد هو الحجة على الناس في عملية تحقيق مشروع الكمال في الواقع الذاتي والاجتماعي، ومن هنا جاء طرح القرآن الكريم لمفهوم المطهّرين الذين أذهب الله عنهم الرجس، وهو المرادف الموضوعي والاجتماعي للكاملين من الناس، وقد عبّر القرآن الكريم والرسول الأعظم بأوصاف متعددة أنه لا خيار لطلب الكمال إلّا من خلال هؤلاء المطهّرين وهو ما يترآى لنا واضحا من حديثه صلوات الله عليه وآله عن الناظم التشريعي للكمال والوجود الاجتماعي له حينما تحدّث عن القرآن الكريم بعنوانه هذا الناظم، وعن عترته المطهّرين بعنوانهم المجسّد الاجتماعي لمشروع الكمال: (ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا) والحديث عن نفي الضلال الدائم هو نفس الحديث عن الكمال التام، فتنبّه! ولهذا جاء مفهوم الإمامة كتعبير واقعي عن هذا المشروع وهو المفهوم الذي طرحه القرآن باعتباره النافي للظلم والمضاد له بقوله: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمّهنّ قال: إني جاعلك للناس إماماً قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين) البقرة: 124، فالكلمات التي اتمّها إبراهيم عليه السلام هي رحلته باتجاه الكمال الذاتي، وحينما أنهى هذه الرحلة وأتمّ مستلزماتها وممتطلباتها رقى إلى مقام الإمامة الذي صوّرته الآية بالمناقض للظلم، ولهذا قال بأن المقام لا يصلح له الظلمة، وأنه خاص بالكمّل من الناس.
وقد طرح القرآن بموازاة ذلك كله أن الأرض التي أودعها الله فيها كل شيء للحياة الكاملة، وسخّر فيها كل شيء لتحقيق ذلك، لا بد لها من إدارة لتحقيق الكمال المرجو من الذين يعيشون فيها بقوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة)، إذ لا يمكن للكامل الرباني إلّا أن يستخلف من يليق بكماله، وقد اعترضت الملائكة على هذه الإدارة لأنها تحتاج إلى كاملين ليحققوا هذا الكمال ويجسّدوه، فقالت وهي تصف الحال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فالذي يفعل ذلك لا يمكن أن يحقق عكسه، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، وعرضوا أنفسه كبديل لتحقيق هذا الكمال ووصفوا أنفسهم بصفات الكمال بقولهم: (ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك) سورة البقرة: 30، ولكنها صعقت حينما قيل لها إنها لا تعلم بمن أعدّ لهذه المهمة، والقرآن لم يكذّبها في حديثها عن سجية الناس المتصارعة والمفسدة لجمال ما في هذه الأرض، ولكنه نفى عنها العلم بطبيعة ما تم إدخاره لهذه المهمة، عبر هذا الجواب المسكت: إني أعلم ما لا تعلمون، وكانت الأنوار المطهّرة المسبّحة حول العرش هي التي لم تعلم بها، ولذلك حينما أعلمها آدم بطبيعة هذه الأنوار (وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم) أذعنت بشكل شديد مع الاعتذار (سبحانك لا علم لنا إلّا ما علمتنا)، وما كانت لتعتذر وتذعن لو لا أنها رأت صورة غير الصورة التي كانت قد رأتها من قبل ذلك والمتمثلة بصراعات ما قبل عصر النبوة، ولا يوجد أدنى شك بأن المشروع الرباني المتمثل بالخلافة الربانية على هذه الأرض لا يمكن أن ينقطع لحظة واحدة عنها، وإلا انتفى الجعل الرباني المشار إليه بقوله: (إني جاعل في الأرض خليفة).
وعليه كان مشروع المطهّرين الإثني عشر من الأئمة صورة كمال تام تواجد مع الناس وعرض كماله عليهم ليسيروا على خطى ذلك الكمال، وقد حبّب الله ذلك للمؤمنين فألزمهم بالاتباع لهؤلاء عبر قوله على لسان رسول الله صلوات الله عليه وآله: (قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى) والتي لا يمكن أن تصلح ضمن نطاق حديثنا هنا إلّا للكمّل من قرباه صلوات الله عليه وآله، ويظهر معها سخف التفسيرات التي ابتعدت عن هذا الفهم وحملت المودة المطلوبة على تعويم هذا المفهوم بدلاً من تخصيصه، فاخرجت الآية عن مجال التطبيق الاجتماعي، بل وأماتتها حينما حصرت المهمة بزمن تاريخي محدد هو زمن رسول الله صلوات الله عليه وآله، ولم ينهض الناس بمسؤولياتهم التي عاهدوا الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله على الإلتزام بها وبايعوه عليها، ولم يسمحوا لمشروع الكمال أن يتحقق، لهذا كانت النتيجة العملية أن نجد أن مشروع الإنقاذ المحمدي مرّ كالطيف، وجاءت السقيفة وإفرازاتها وجاء العهد الأموي ومن بعده العباسي وصولاً إلى يومنا هذا وهو يحكي مرارة التجربة الإنسانية، فمن ظلم لآخر ومن جور إلى آخر، ولا يوجد في الأفق البشري المتصوّر إلّا المزيد من هذا الظلم والجور.
ومن هنا كان مشروع الإمامة صالحاً في كل زمان في أن يحقق ما تمّ إيكاله بالنتيجة للإمام المنتظر صلوات الله عليه في أن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وهو المعبّر عن مشروع الكمال هذا، فالأئمة صلوات الله عليهم في كل واحد منهم يوجد مشروع القيام من أجل تطبيق الكمال، ومن هنا كان حديث الإمام الباقر عليه السلام الذي يرويه أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن دينار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: " إلى السبعين بلاء" وكان يقول: "بعد البلاء رخاء" وقد مضت السبعون ولم نر رخاء! . فقال أبو جعفر عليه السلام: يا ثابت إن الله تعالى كان وقّت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين عليه السلام اشتد غضب الله على أهل الأرض ، فأخّره إلى أربعين ومائة سنة، فحدّثناكم فأذعتم الحديث، وكشفتم قناع السر، فأخّره الله، ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتاً، و(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) الرعد: 39 (غيبة الشيخ الطوسي: 428 ح417).
وكذا ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق قال: قلت له: ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال: بلى، ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه. (غيبة الشيخ النعماني: 299 ب16 ح1).
ففي الروايتين وعدد آخر من الروايات يؤكد الإمام صلوات الله عليه بأن مشروع النهوض من أجل دحر الظلم والجور قائم في كل عصر، ولكن حينما يتخلّف الناس عن النوء بمسؤولياتهم تحصّل عملية التأخير، وفي استشهاده بالآية الكريمة تنبيه مهم للغاية وهو أن هذا التأخير الذي حصل يمكن أن يطرأ عليه تغيير تقدّماً وتأخّراً، لأن الأمر مرتبط بوجود المناصر الواعي بمستلزمات مشروع العدل والقسط الذي طرح بعنوانه الشق الثاني من المشروع الإنقاذي للعالم والمتمثل بمشروع الإمام المهدي صلوات الله عليه.
وبسبب الانتظار لإدراك الناس لمسؤولياتهم ورقيّهم لتحمّل أعبائها كان عمر الإمام المنتظر صلوات الله عليه طويلاً، وسمّيت الفترة التي طال فيها عمره الشريف بفترة الإنتظار، إذ لا معنى لهذا الانتظار إلّا من خلال الرقي بوعي الناس إلى مستوى مسؤولية احتضان المشروع المنقذ لهم، مما جعل الإنتظار أفضل الأعمال، كما لا معنى لطول عمر الإمام صلوات الله عليه إلّا هذا المعنى، ومعهما لا معنى للغيبة إلّا هذا المعنى، فالمنقذ حاضرٌ بيننا، ومن لا يرقى لمستوى مهمة الإنقاذ لا يمكن له أن يوفق له.
وكل ذلك هو الذي يفسّر لنا لم لم يتماثل دور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف مع دور الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ فمن الواضح أن الإمام الحسين عليه السلام أقبل على المواجهة الحاسمة مع الظلم مع يقينه بأنه بأبي وأمي سيستشهد، بينما نرى الإمام المنتظر عجل الله فرجه قد آثر أن يبتعد عن الصدام مع نمط آخر من أنماط الظلم، وفي وقت كان جدّه بأبي وأمي قد أصرّ على الوجود المعلن المجاهر بالمشروع العادل، انتخب الإمام المنتظر روحي فداه الغياب عن العلن والنزول بالمشروع العادل إلى ساحة خفية، وما من شك أن الأئمة يختلفون في الدوار ولكن هدفهم واحد، وسبب الإختلاف هو مستوى قابلية الناس لحمل أعباء المشروع الإنقاذي الذي طرحه الإمام الحسين صلوات الله عليه بقوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد، وطرح في مشروع الإمام المنتظر عجل الله فرجه لتحقيق القسط والعدل.
وعليه فإن المُنقذ سواء كان نتيجة لطلب الكمال، أو الرغبة في تخلّص الضعفاء من ظلم الأقوياء يمثّل في المحصّلة نفس الواجهة، ولكن أحدهما طلبه لأنه يمثل سجية في داخل الذات، والآخر طلبه لأن الواقع الإجتماعي يدعو إليه، وما بين هذا وذاك ظلت عقيدة المُنقذ هي الأكثر حضوراً في التاريخ البشري.